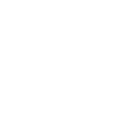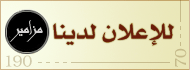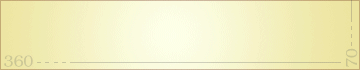- 8 مايو 2008
- 1,568
- 0
- 0
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- محمود خليل الحصري
رد: شرح الشاطبية لابن شامة
(232)
لِقَالُونَ وَالْبَصْرِي وَتُهْمَزُ وَاوُهُ لِقَالُونَ حَالَ النَّقْلِ بَدْءًا وَمَوْصِلاَ
أي أن قالون يهمز واو لولى إذا بدأ بالنقل وفي الوصل مطلقا أي حيث قلنا لقالون بالنقل سواء ابتدأ الأولى أو وصلها بعادا فواو لولى مهموز بهمزة ساكنة وإن قلنا يبتدئ بالأصل فلا همز لئلا يجتمع همزتان فهذا معنى قوله حال النقل ووجه الهمز ضمة اللام قبلها فهمزت لمجاورة الضم كما همزت إذا كانت مضمومة في أجوه وأدور وهي لغة لبعض العرب كقوله أحب المؤقدين إلى موسى وهذا توجيه أبي علي في الحجة وقيل الأصل في الواو الهمز وأبدل لسكونه بعد همز مضموم واوا كأولى فلما حذفت الهمزة الأولى بعد نقل حركتها إلى لام الأولى زال اجتماع الهمزتين فرجعت تلك الهمزة ذكر ذلك مكي وغيره ، والله أعلم ، ومادة هذه الكلمة مختلف فيها وهي من المشكلات وسنتكلم عليها في شرح النظم إن شاء الله تعالى كلاما شافيا وبالله التوفيق ، وقوله بدءا وموصلا مصدران في موضع الحال أي بادءاً وواصلاً ، ثم ذكر كيفية البدء في حال النقل فقال
(233)
وَتَبْدَأْ بِهَمْزِ الْوَصْلِ في النَّقْلِ كُلِّهِ وَإِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِعَارِضِهِ فَلاَ
أبدل من همز وتبدأ ألفا بعد إسكانها ضرورة ، وقوله بهمز الوصل يعني همزة الوصل التي تصحب لام التعريف تقول إذا ابتدأت كلمة دخل فيها لام التعريف على ما أوله همزة قطع نحو-الأرض-و-الآخرة-والإنسان-و-الإحسان-فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم أردت الابتداء بتلك الكلمة بدأت بهمزة الوصل كما تبتدئ بها في صورة عدم النقل لأجل سكون اللام فاللام بعد النقل إليها كأنها بعد ساكنة لأن حركة النقل عارضة فتبقى همزة الوصل على حالها لا تسقط إلا في الدرج ، وهذا هو الوجه المختار لغة وقراءة على ما سيأتي تقريره ثم ذكر وجها آخر وهو أن لا يحتاج إلى همزة لوصل لأنها إنما اجتلبت لأجل سكون اللام وقد زال سكونها بحركة النقل العارضة فاستغنى عنها فهذا معنى قوله وإن كنت معتدا بعارضه أي منزلا لحركة النقل منزلة الحركة الأصلية فلا تبدأ بهمز الوصل إذ لا حاجة إليه فتقول على الوجه الأول-ألرض-ألنسان-وعلى الثاني-لرض-لنسان-وعادة أهل النحو يمثلون في هذه المسألة بالأحمر فتقول على الوجه الأول الحمر وعلى الثاني لحمر ، وقوله في النقل كله ليشمل جميع ما ينقل إليه ورش من لام المعرفة ويدخل في ذلك الأولى من-عادا لولى-فيكون الوجهان لورش في جميع القرآن ويكونان لأبي عمرو وقالون في هذا الموضع إن قلنا إنهما يبدآن بالنقل كما في الوصل وإن قلنا يبدآن بالأصل من غير نقل فلا بد من همزة الوصل فقد صار لكل واحد منهما ثلاثة أوجه في صوره الإبتدا بقوله تعالى-الأولى-من عادا لولى ولورش وجها ، كما له في سائر القرآن على ما ذكرنا هكذا ذكر صاحب التيسير وغيره من المصنفين في القراءات وتبعهم الشيخ الشاطبي رحمه الله في نظمه هذا وفيه إشكال وهو أن النحاة ذكروا وجهين في أن حركة النقل يعتد بها أولا وأجروا على كل وجه ما يقتضي من الأحكام لم يخصوا بذلك دخول همزة الوصل وعدم دخولها بل قالوا إن اعتددنا بالعارض فلا حاجة إلى تحريك النون في من لأن بل تبقى على سكونها إذ لم يلتق ساكنان وإن لم نعتد بالعارض أبقينا فتحة النون على حالها قبل النقل فإذا اتضح ذلك وجب النظر في مواضع النقل في القرآن فما رأينا فيه أمارة الاعتداد بالعارض حذفنا همزة الوصل في الابتداء به وما رأينا فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض أبقينا همزة الوصل فيه وما لا أمارة فيه على واحد منهما ففيه الوجهان وهذا تحقيق البحث في ذلك إن شاء الله تعالى فنقول ، في مسألة-عادا لولى-ظهرت أمارة الاعتداد بالعارض في قراءة أبي عمرو ونافع معا وذلك أنهما أدغما في الوصل التنوين في اللام فهذه أمارة الاعتداد بحركة اللام فإذا ابتدأ القارئ لهما بالنقل لم يحتج إلى همزة الوصل لأنا قد علمنا أن الحركة معتد بها عندهما وصلا فابتنى الابتداء عليه وقد نص أبو محمد مكي في كتاب الكشف على أن ورشا لا يمد-الأولى-وإن كان من مذهبه مد حرف المد بعد الهمز المغير لأن هذا وإن كان همزا مغيرا إلا أنه قد اعتد بحركة اللام فكان لا همز في الكلمة فلا مد ، قلت هكذا ينبغي في القياس أن لا تعود همزة الوصل في الابتداء ، والله أعلم ، ونقول في جميع ما نقل فيه ورش الحركة إلى لام المعرفة في جميع القرآن غير-عادا لولى-هو على قسمين ، أحدهما ما ظهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض كقوله تعالى (إنا جعلنا ما على الأرض)-(وما الحياة الدنيا في الآخرة)-(ويدع الإنسان)-(قالوا الآن)-(أزفت الآزفة) ، ونحو ذلك ألا ترى أنه بعد نقل الحركة في هذه المواضع لم ترد حروف المد التي حذفت لأجل سكون اللام ولم تسكن تاء التأنيث التي كسرت لسكون -الآزفة-فعلمنا أنه ما اعتد بالحركة في مثل هذه المواضع فينبغي إذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأتي بهمزة الوصل لأن اللام وإن تحركت فكأنها بعد ساكنة ، القسم الثاني ما لم تظهر فيه أمارة نحو (وقال الإنسان ما لها) ، فإذا ابتدأ القارئ لورش هنا اتجه الوجهان المذكوران والله أعلم
(234)
وَنقْلُ رِدًا عَنْ نَافِعٍ وَكِتَابِيهْ بِالإِسْكانِ عَنْ وَرْشٍ أَصَحُّ تَقَبَّلاَ
لو أتى بهذا البيت قبل مسألة-عادا لولى-لكان أحسن ليتصل مذهب نافع بكماله يتلو بعضه بعضا وليفرغ مما روي عن ورش الانفراد بنقله ثم يذكر من وافقه في شيء من مواضع النقل كما هي عادته غالبا في باقي الأبواب وإنما أخر هذا البيت لأن النقل في كتابيه ضعيف والنقل في ردا على خلاف أصل ورش لأنه لا ينقل في كلمة وأراد قوله تعالى (فأرسله معي ردءا) ، أي معينا قراءة نافع بغير همز كما يقف عليه حمزة بنقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة وقيل هو من أردى على كذا أي زاد فلا همز فيه أي أرسله معي زيادة وأما قوله تعالى في الحاقة (كتابيه إني ظننت) ، فروي عن ورش نقل حركة همزة إني إلى هاء كتابيه لأنه ساكن آخر صحيح فدخل في الضابط المذكور أول الباب وروى ترك النقل وهو الصحيح في العربية لأن هذه الهاء هاء سكت وحكمها السكون لا تحرك إلا في ضرورة الشعر على قبح وأيضا فإنها لا تثبت إلا في الوقف فإذا خولف الأصل فأثبتت في الوصل إجراء له مجرى الوقف لأجل ثباتها في خط المصحف فلا ينبغي أن يخالف الأصل من وجه آخر وهو تحريكها فتجتمع في حرف واحد مخالفتان وهذه المسألة من الزيادات لم يذكرها الداني رحمه الله في التيسير وذكرها في غيره ، قال مكي أخذ قوم بنقل الحركة في هذا وتركه أحسن وأقوى ، قلت فلهذا قال الناظم أصح تقبلا-أي وكتابيه-بالإسكان أصح تقبلا منه بالتحريك وذلك أن التحريك تقبله قوم وتقبل الإسكان قوم فالإسكان أصح تقبلا من حيث الدليل على ما سبق ونصبه على التمييز وبالإسكان حال أي وكتابيه ساكنا أصح تقبلا منه متحركا فهو مثل قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا والله أعلم
(232)
لِقَالُونَ وَالْبَصْرِي وَتُهْمَزُ وَاوُهُ لِقَالُونَ حَالَ النَّقْلِ بَدْءًا وَمَوْصِلاَ
أي أن قالون يهمز واو لولى إذا بدأ بالنقل وفي الوصل مطلقا أي حيث قلنا لقالون بالنقل سواء ابتدأ الأولى أو وصلها بعادا فواو لولى مهموز بهمزة ساكنة وإن قلنا يبتدئ بالأصل فلا همز لئلا يجتمع همزتان فهذا معنى قوله حال النقل ووجه الهمز ضمة اللام قبلها فهمزت لمجاورة الضم كما همزت إذا كانت مضمومة في أجوه وأدور وهي لغة لبعض العرب كقوله أحب المؤقدين إلى موسى وهذا توجيه أبي علي في الحجة وقيل الأصل في الواو الهمز وأبدل لسكونه بعد همز مضموم واوا كأولى فلما حذفت الهمزة الأولى بعد نقل حركتها إلى لام الأولى زال اجتماع الهمزتين فرجعت تلك الهمزة ذكر ذلك مكي وغيره ، والله أعلم ، ومادة هذه الكلمة مختلف فيها وهي من المشكلات وسنتكلم عليها في شرح النظم إن شاء الله تعالى كلاما شافيا وبالله التوفيق ، وقوله بدءا وموصلا مصدران في موضع الحال أي بادءاً وواصلاً ، ثم ذكر كيفية البدء في حال النقل فقال
(233)
وَتَبْدَأْ بِهَمْزِ الْوَصْلِ في النَّقْلِ كُلِّهِ وَإِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِعَارِضِهِ فَلاَ
أبدل من همز وتبدأ ألفا بعد إسكانها ضرورة ، وقوله بهمز الوصل يعني همزة الوصل التي تصحب لام التعريف تقول إذا ابتدأت كلمة دخل فيها لام التعريف على ما أوله همزة قطع نحو-الأرض-و-الآخرة-والإنسان-و-الإحسان-فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم أردت الابتداء بتلك الكلمة بدأت بهمزة الوصل كما تبتدئ بها في صورة عدم النقل لأجل سكون اللام فاللام بعد النقل إليها كأنها بعد ساكنة لأن حركة النقل عارضة فتبقى همزة الوصل على حالها لا تسقط إلا في الدرج ، وهذا هو الوجه المختار لغة وقراءة على ما سيأتي تقريره ثم ذكر وجها آخر وهو أن لا يحتاج إلى همزة لوصل لأنها إنما اجتلبت لأجل سكون اللام وقد زال سكونها بحركة النقل العارضة فاستغنى عنها فهذا معنى قوله وإن كنت معتدا بعارضه أي منزلا لحركة النقل منزلة الحركة الأصلية فلا تبدأ بهمز الوصل إذ لا حاجة إليه فتقول على الوجه الأول-ألرض-ألنسان-وعلى الثاني-لرض-لنسان-وعادة أهل النحو يمثلون في هذه المسألة بالأحمر فتقول على الوجه الأول الحمر وعلى الثاني لحمر ، وقوله في النقل كله ليشمل جميع ما ينقل إليه ورش من لام المعرفة ويدخل في ذلك الأولى من-عادا لولى-فيكون الوجهان لورش في جميع القرآن ويكونان لأبي عمرو وقالون في هذا الموضع إن قلنا إنهما يبدآن بالنقل كما في الوصل وإن قلنا يبدآن بالأصل من غير نقل فلا بد من همزة الوصل فقد صار لكل واحد منهما ثلاثة أوجه في صوره الإبتدا بقوله تعالى-الأولى-من عادا لولى ولورش وجها ، كما له في سائر القرآن على ما ذكرنا هكذا ذكر صاحب التيسير وغيره من المصنفين في القراءات وتبعهم الشيخ الشاطبي رحمه الله في نظمه هذا وفيه إشكال وهو أن النحاة ذكروا وجهين في أن حركة النقل يعتد بها أولا وأجروا على كل وجه ما يقتضي من الأحكام لم يخصوا بذلك دخول همزة الوصل وعدم دخولها بل قالوا إن اعتددنا بالعارض فلا حاجة إلى تحريك النون في من لأن بل تبقى على سكونها إذ لم يلتق ساكنان وإن لم نعتد بالعارض أبقينا فتحة النون على حالها قبل النقل فإذا اتضح ذلك وجب النظر في مواضع النقل في القرآن فما رأينا فيه أمارة الاعتداد بالعارض حذفنا همزة الوصل في الابتداء به وما رأينا فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض أبقينا همزة الوصل فيه وما لا أمارة فيه على واحد منهما ففيه الوجهان وهذا تحقيق البحث في ذلك إن شاء الله تعالى فنقول ، في مسألة-عادا لولى-ظهرت أمارة الاعتداد بالعارض في قراءة أبي عمرو ونافع معا وذلك أنهما أدغما في الوصل التنوين في اللام فهذه أمارة الاعتداد بحركة اللام فإذا ابتدأ القارئ لهما بالنقل لم يحتج إلى همزة الوصل لأنا قد علمنا أن الحركة معتد بها عندهما وصلا فابتنى الابتداء عليه وقد نص أبو محمد مكي في كتاب الكشف على أن ورشا لا يمد-الأولى-وإن كان من مذهبه مد حرف المد بعد الهمز المغير لأن هذا وإن كان همزا مغيرا إلا أنه قد اعتد بحركة اللام فكان لا همز في الكلمة فلا مد ، قلت هكذا ينبغي في القياس أن لا تعود همزة الوصل في الابتداء ، والله أعلم ، ونقول في جميع ما نقل فيه ورش الحركة إلى لام المعرفة في جميع القرآن غير-عادا لولى-هو على قسمين ، أحدهما ما ظهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض كقوله تعالى (إنا جعلنا ما على الأرض)-(وما الحياة الدنيا في الآخرة)-(ويدع الإنسان)-(قالوا الآن)-(أزفت الآزفة) ، ونحو ذلك ألا ترى أنه بعد نقل الحركة في هذه المواضع لم ترد حروف المد التي حذفت لأجل سكون اللام ولم تسكن تاء التأنيث التي كسرت لسكون -الآزفة-فعلمنا أنه ما اعتد بالحركة في مثل هذه المواضع فينبغي إذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأتي بهمزة الوصل لأن اللام وإن تحركت فكأنها بعد ساكنة ، القسم الثاني ما لم تظهر فيه أمارة نحو (وقال الإنسان ما لها) ، فإذا ابتدأ القارئ لورش هنا اتجه الوجهان المذكوران والله أعلم
(234)
وَنقْلُ رِدًا عَنْ نَافِعٍ وَكِتَابِيهْ بِالإِسْكانِ عَنْ وَرْشٍ أَصَحُّ تَقَبَّلاَ
لو أتى بهذا البيت قبل مسألة-عادا لولى-لكان أحسن ليتصل مذهب نافع بكماله يتلو بعضه بعضا وليفرغ مما روي عن ورش الانفراد بنقله ثم يذكر من وافقه في شيء من مواضع النقل كما هي عادته غالبا في باقي الأبواب وإنما أخر هذا البيت لأن النقل في كتابيه ضعيف والنقل في ردا على خلاف أصل ورش لأنه لا ينقل في كلمة وأراد قوله تعالى (فأرسله معي ردءا) ، أي معينا قراءة نافع بغير همز كما يقف عليه حمزة بنقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة وقيل هو من أردى على كذا أي زاد فلا همز فيه أي أرسله معي زيادة وأما قوله تعالى في الحاقة (كتابيه إني ظننت) ، فروي عن ورش نقل حركة همزة إني إلى هاء كتابيه لأنه ساكن آخر صحيح فدخل في الضابط المذكور أول الباب وروى ترك النقل وهو الصحيح في العربية لأن هذه الهاء هاء سكت وحكمها السكون لا تحرك إلا في ضرورة الشعر على قبح وأيضا فإنها لا تثبت إلا في الوقف فإذا خولف الأصل فأثبتت في الوصل إجراء له مجرى الوقف لأجل ثباتها في خط المصحف فلا ينبغي أن يخالف الأصل من وجه آخر وهو تحريكها فتجتمع في حرف واحد مخالفتان وهذه المسألة من الزيادات لم يذكرها الداني رحمه الله في التيسير وذكرها في غيره ، قال مكي أخذ قوم بنقل الحركة في هذا وتركه أحسن وأقوى ، قلت فلهذا قال الناظم أصح تقبلا-أي وكتابيه-بالإسكان أصح تقبلا منه بالتحريك وذلك أن التحريك تقبله قوم وتقبل الإسكان قوم فالإسكان أصح تقبلا من حيث الدليل على ما سبق ونصبه على التمييز وبالإسكان حال أي وكتابيه ساكنا أصح تقبلا منه متحركا فهو مثل قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا والله أعلم